تظل الرواية ظاهرة مثيرة للجدل ، لا على مستوى البناء الحداثي الذي تصبو إليه من خلال أعمال رائدة فحسب ، بل على مستوى المضامين أيضا ، التي تؤلف بين بنياتها ، والقضايا الحاسمة و المصيرية ، التي تتشكل من داخلها . فإن كانت الغاية التي تطمح إليها هي خلخلة واقع موبوء و نفض الغبار عن مصير أو انتماء ؛ فإنها ، بذلك ، تشغل بال الفكر وتؤرق الواقع أيضا ، بل تذهب إلى حدود أن تلامس الوجدان الإنساني ، مادامت المعاناة قضية شاملة للوجود ككل ، بما هي ـ أي المعاناة ـ خيط ناظم ، على امتداد التاريخ الثقافي والفكري ، للكل التجارب الإنسانية . فبالحديث عن الرواية ، كتجربة إبداعية ، نطل من خلالها على رمزية الوجود في أسمى معانيه . فضلا على استبانة ، أمام ضمير العالم ، حق تقرير المصير الفردي والجماعي .و خصوصا إذا ما انفتحت الرواية على تجربة الآخر ، من خلال نقلها إلى لغات أخرى بفعل الترجمات ، التي غالبا ما تفنن في صيد وانتقاء مفرداتها ، وعباراتها السابحة في ماء الحكاية . فمن بين الروايات العربية التي تتقلب في وجداننا و تقض مضاجعنا ، بل تنغص الضمائر الحية ، وتجعلنا أمام شلال من الأضواء الكاشفة للذات و للآخرين ؛ الرواية الفلسطينية .
في الأدبيات الحديثة و المعاصرة ، ارتبط الإبداع الفلسطيني عموما بالمقاومة ، كشكل من أشكال إثبات الذات ، والحضور الفعلي الدائم في الساحة الثقافية و الفنية ؛ العربية و غير العربية . إن المقاومة بالأدب لم تثبت جدارتها ، في الساحة الثقافية ، إلا بعد ما تمَّ احتلال فلسطين ، في منتصف القرن الماضي ، من طرف الصهاينة . فبات من الواضح جدا أن نجد هذا الإبداع يقاوم من أجل العيش والكرامة و الوجود و الهوية . فتدبير مسألة الهوية ، مثلا ، ولمِّ الشتات في الثقافة الفلسطينية ، لم يعد مرتبطا فقط بالخيال الإبداعي ، وإنما اكتسح كل الروافد المعرفية والعلمية ، الطامحة نحو خلق جبهة مقاومة حقيقية ، تقف ندا أمام سياسة طمس و إقبار وتدمير الثقافة الفلسطينية . لقد كان الكيان الغاشم يدرك ، آنئذ ، مدى فعالية تغيير البنية المجتمعية و الثقافية ؛ بفعل ترحيل قسري للسكان الفلسطنيين ، وتهجيرهم خارج الوطن . غير أن المقاومة بالثقافة و الإبداع ، ظل يؤرق الكيان الصهيوني ، و شوكة في حلقه ردحا من الزمن . فما كانت قصائد الشاعر الفلسطيني سميح القاسم سوى جمرات متقدة و لافحة على الطريق ؛ تقاوم بإرادة متحررة من كل أنواع الحيف والظلم ، وتكشف ألاعيب الغاصب الغاشم . فقصيدته التي عنونها ب ” والمواعيد أنا ” فجر فيها ينابيع شهوة القول الشعري ، مبئرا نكبة النازحين الفلسطينيين ، بشهادة نقاد يتابعون عن كثب تطورات و إبدالات التجربة الشعرية لسميح القاسم . كان مطلعُ القصيدة من بحر الرمل :
” شهوة الكدح من الفجر ، وموال الإياب
مسرب الوعر ، وآلاف الأكف السمر
ترتاح على مقبض باب
والمواعيد أنا ، وزغرودة الميلاد
والدمع على تطريز منديل اغتراب
وأنا نعناعة التل
أنا النبع و غصن الورد
والمرزاب و المدفأة المهجورة
السطح … أنا سنبلة الحقل
الشجيرات … ودوري القباب
كنت راعي الغنم الأسمر ” .
وفي ذات المسعى ، كيف يكون الإبداع من دون وطن ؟ أكيد أن للوطن حميميتـَه و دفْأه ، اللذين يؤمِّنان فعل العبور نحو ضفاف فسيحة من القول و الحكي . إلا أن الأدبَ ، في فلسطين ، أبى إلا أن يكون غير ذلك ، ويغرد خارج السرب ؛ ينصت لدقات قلبه ، بل يسيخ السمع لوثبات الموت تدبُّ رويدا … رويدا ؛ فيُبعث من تحت الرماد كالطائر الفينيق ، بما هي الأسطورة التي تشبع بها أغلب أدباء فلسطين . بالموازاة ، مع ذلك ، نجد الغربة والضياع ، كتجربة ، ألفت بينهم ، ورصَّت دعائم المقاومة في ظل انقسام جَلَّاء بين من يحسون بالغربة خارج الوطن ، وبين من استأنسوا بها ، وتعايشوا معها من داخله . فجبرا إبراهيم جبرا عاش متنقلا بين مختلف العواصم العربية ؛ من بيروت إلى دمشق مرورا ببغداد والقاهرة ، كما هو شأن بالنسبة لغسان كنفاني و الكاريكاتوري ناجي العلي صاحب الرمز المبيان ، الذي نحته في الصخر البرونزي ؛ ” حنضلة ” . أما الغربة الغريبة التي عاشها المبدع الفلسطيني من داخل فلسطين ؛ فإننا نجد صاحب الورد الأقل ، وملهم القصيدة العربية محمود درويش برفقة رفيق دربه سميح القاسم و توفيق زياد بالإضافة إلى المتشائل إميل حبيبي .
إن هذه المقاومة ، التي أبداها الأدب الفلسطيني ، تدافع عن حصون الثقافة العربية العريقة ، إما بالعودة إلي تلك المنابع الطاهرة من تاريخ الأدب العربي ، لإثبات و تأصيل الهوية للأدب الفلسطيني ، وبذلك تقف كالطود العظيم ، أمام سياسة التهجين و الذوبان في ثقافات وافدة مع الكيان الصهيوني ، وإما التوفيق بين ما هو عريق ، و في الوقت نفسه التطلع إلى ما هو حديث ، دون التفريط في هوية الشعب الفلسطيني . وأمام هذه الإشكالية في تاريخ الأدب العربي ، نجد بالمقابل أن التأريخ الجديد لأهم الإبدالات الثقافية ، في مختلف فنون الأدب ، يبدأ مع نكبة الاحتلال ، وسياسة تهجير الفلسطينيين ؛ ليعيش الأديب تجربة الضياع و البحث عن وطن بديل ، حاملا معه هموم وطنه الأسير . ففي مثل هذه الظروف العصيبة ، التي يمر منها الشعب الفلسطيني ، أكد يحيى يخلف أن الرواية الفلسطينية تأثرت ، إلى حد كبير ، بهذه الاضطرابات و الإحباطات الخطيرة ، ومن ثم أصبح الروائي الفلسطيني يبحث عن لغة جديدة ، بل عن شكل جديد في أفق مرحلة تتسم بالضيق و قمع الحريات الفكرية و السياسية . وغير خاف علينا أن بهذه الظروف ستسعى الرواية الفلسطينية إلى فتح جبهات النضال و الثورة ، وتلتصق بهموم الإنسان الفلسطيني والعربي . وفي ضوء ذلك ، أخذت الرواية سكة الكفاح الوطني ؛ فجاءت أعمال كل من إميل حبيبي وغسان كنفاني بالإضافة إلى توفيق فياض و أفنان القاسم و رشاد أبو شاور وغيرهم ، تتغنى بالأمل في الحياة ، وحق العودة إلى الوطن السليب . فبهذه الخامات الأدبية الرفيعة ، استطاع الأدب الفلسطيني أن يجد له موطئ قدم في الساحة الثقافية العربية و غير العربية .
في ظل متغيرات الإبداع ، التي تفرضها الظروف السياسية و الإجتماعية الجديدة ، في بلاد فلسطين ، استطاع الروائيون السابقون ، أن يدشنوا الدخول الثقافي و الأدبي قبل النكبة والتهجير . وكان في مقدمتهم اسكندر خوري و نجاتي صدقي و صاحب رواية ” الوارث ” خليل بيدس وغيرهم كثير . غير أن الذين أرسوا دعائم الرواية الفلسطينية بشكل رسمي ، وخاضع لمعايير فنية شائقة ، وجعلوا لها وجودا في الساحة العربية و الدولية نجد كل من غسان كنفاني و جبرا إبراهيم جبرا وأخيرا إميل حبيبي .
إن الحديث عن الرواية الفلسطينية ، التي تلهج و تدافع عن حق الحلم والانتماء ، لا يستقيم عوده إلا بذكر هذا الثالوث ، الذي كان ينظر إلى الوجود و الكون نظرة تدافع عن الهوية الفلسطينية ، وتذود عن العودة إلى الديار كحق من حقوق الإنسان ، تضمنه المواثيق والمنتظمات الدولية . ففي إبداعات غسان كنفاني ، التي تستند إلى قوة الفكرة و الموقف ، يرصد أهم التغيرات و الإبدالات التي مر منها الإنسان الفلسطيني بعد إعلان عن دولة عبرية في قلب الأمة العربية ، بل يصور شخصياته من واقع الانسان العربي المهزوم . فرواية ” رجال في الشمس ” لغسان كنفاني ، رسم فيها واقع الإنسان الفلسطيني من خلال استئصاله من أرضه ، و تهجيره بواسطة عصابات مدربة على ذلك ، تشبه إلى حد ما فعلته النازية في أوروبا ؛ إبان الحرب العالمية الثانية . فضلا عن ذلك ، استطاع أن يرفع القضية الفلسطينية إلى مصاف القضايا الإنسانية. لتبقى عبارة ” لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟” على لسان أبي الخيزران ، جاثمة على كل الصدور والضمائر الحية . إن غسان كنفاني استطاع أن يجعل من الكلم سلاحا مزعجا ، يؤرق بها الأعداء ، علاوة على ارتباطه الجامد بالوطن ؛ فلسطين . ففي باقي أعماله الرائدة الأخرى ؛ ” ما تبقى لكم ” و ” برقوق نيسان ” انتقل فيهما من الحكي إلى الفعل الحقيقي والمواجهة الموت بصدر عار ، لا يخشى المنايا التي لا تطيش سهامها . فهو كفاح بالقلم ، جعل من أرض فلسطين بؤرة الصراع التاريخي ؛ بؤرة تتقاتل و تتصارع فيها الأديان السماوية . فهي لم تعد مجرد حفنة من تراب فحسب ، وإنما هي دم و روح وجسد ينبغي أن يخضع لعملية التطهير و الطهارة من كل الشوائب التي علقت به جراء التهجير القسري الذي تعرض له فلسطينيو ثمانية وأربعين ، الذين اعتبروا بمثابة حجر الزاوية في أي حل مرتقب لهذا الصراع الحضاري . لقد استطاع غسان أن يتفرد في إبداعاته ؛ ” عائد إلى حيفا ” و ” أم سعد ” كي يرسم معالم الإنسان الفلسطيني ، و يرسخه بشكل مطلق في الوجدان البشري . يقول غسان في روايته ” عائد إلى حيفا ” :
” وضع إصبعه على الجرس ، وهو يقول بصوت خافت لصفية :
ـ غيروا الجرس .
ـ وسكت قليلا ثم تابع :
ـ و الإسم طبعا …” .
إن الرمزية ، عند غسان كنفاني ، تتجاوز الجاهز و المألوف ، و تضعنا أمام اختيارات صعبة ، لا على مستوى الأحداث فقط ، وإنما على صعيد الرؤية الفنية التي تسكن الروائي. فبهذا يؤثث فضاءاته الروائية بما يتناسب و الحلمَ الفلسطيني ، في تقرير مصيره والعودة إلى الديار . وتبعا لذلك ، يجعلنا نطل على عالمه الروائي من شرفات متعددة ؛ نتذوق معه لحظات التأمل في الطريقة التي يعرض ، بفنية رائعة هموم و انشغالات الشعب الفلسطيني. علاوة على ذلك ، فالعائد إلى حيفا ، حسب غسان ، هو نفسه العائد إلى عكا ويافا و نابلس و بيسان وطولكرم و جنين و نهاريا و الطنطورية وغيرهم من المدن الفلسطينية سواء منها السليبة أو غير الأسيرة .
يطفح أدب غسان كنفاني بالمواقف السياسية المعروفة ، فهو لم يعد عنده الأدب مجرد رسم الحدود و القبـْع و الانزواء وراء ابتكار الصور الخيالية و الاستعارية ، وإنما هو نشاط يتجاوز به كل المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها المثقف العضوي حسب أنطونيو غرامشي . فلا نستطيع أن نفصل بين غسان الروائي و الآخر القصاص و المناضل السياسي و الصحفي ؛ لذلك أصبح رقما صعبا ، بل هدفا استراتيجيا لقوات الاحتلال ، في إخماد هذا الصوت المزعج الصاعد من عكا ؛ هذه أياد آثمة كانت تسرق القمر ، اختارت مرة أخرى ، تفخيخ و تفجير سيارة غسان أمام أنظار زوجته و ابنته ، تاركا قلمه وأغراضه على مكتبه بالبيت … ورحل بابا بعيدا … بين الغيمات كما قالت ابنته لحظة التفجير .
أما جبرا إبراهيم جبرا يظل هرما في بحر الإبداع الفلسطيني ، تربع على عرش الرواية الفلسطينية لما يزيد عن أربعة عقود ، كتب في مختلف الأجناس الأدبية قبل أن تستقر رؤيته الفنية على جنس الرواية ؛ لما توفره له من مساحة أكبر للتفاعل مع القضايا السياسية والإجتماعية . للسفر و الترحال ، بين مختلف العواصم العربية و غير العربية ، دور أساسي في إغناء تجربته الروائية . فضلا عن تجربة في الإبداع دامت قبل السقطة و بعدها ، فكانت التيمات الروائية التي تناولها جبرا إبراهيم جبرا في مختلف رواياته بدءا من ” صراخ في ليل طويل ” مرورا ب” صيادون في شارع ضيق ” إلى حدود ” البحث عن وليد مسعود ” يجعل القضية الفلسطينية في الجوهر ، بل في قلب الحدث الروائي ، ساعيا في ذلك إلى التعريف بها في مختلف المنابر الإعلامية العربية و غير العربية . إن جبرا إبراهيم جبرا من رعيل المثقفين الفلسطينيين ، الذين يؤمنون بالتغيير عن طريق القوة الإبداعية و الثقافية ، التي تسعى جاهدة إلى تحقيق الحلم ، الذي لا طالما راود كل المثقفين ، الذين يحملون معهم هموم الوطن الأسير . وفي هذا المقام ينضاف جبرا إبراهيم جبرا إلى قائمة الروائيين العالميين الذين يولون اهتماما كبيرا إلى شخصيات الرواية أمثال ؛ إميل زولا و غي موبسان وبروست ، بما هي الوسيلة التي تعبر عن الرؤى الفنية والدواخل . ففي رواية ” البحث عن وليد مسعود ” تتحول الشخصية الرئيسة ، في النص الروائي ، إلى الضمير الفلسطيني ، بل إلى الضمير العربي و الإنساني ، المغيب عن ساحة هذا الصراع غير المتكافئ ضد قوى الاحتلال . فمهما كان الاهتمام المتزايد بالشخصيات الروائية ، حسب جبرا إبراهيم جبرا ، فإنه يقع اختياره ، دائما ، على الشخصية النامية . بما هي تنمو وفق الحلم و الشعور والإحساس بالزمن و بالمكان أيضا ، خصوصا إذا كان الروائي يتقن الصناعة و الدُّربة، التي تبني الحدث بمعاييرَ جد فنية . وعلى هذا الأساس ، تصبح البوليفونية تتعدى الأصوات التي تتردد صداها ، وتزمجر من داخل العمل الروائي ؛ لتشمل الشخصيات النامية في نسيج ضام لعُرى العمل الإبداعي . وبشهادة كبار النقاد و المتتبعين للشأن الثقافي العربي ، تعد رواية ” البحث عن وليد مسعود ” اختزالا لحياة جبرا إبراهيم جبرا ، وبهذا المعطى يمكن اعتبارها ، أيضا ، سيرة الكاتب في مرحلة عمرية محددة .
أما الروائي ” إميل حبيبي ” ينتهج أسلوبا متفردا في الرواية الفلسطينية و العربية ، فكان في جل إبداعاته ، لصيقا بالظروف السياسية ، التي أفرزت عالمين غير متكافئين . وبهذه الخصوصية ، يكون أميل حبيبي قد دشن عهدا جديدا مع الإبداع الفلسطيني ، من خلال أهم رواياته الذائعة الصيت . علاوة على ذلك ، فإميل شديد الارتباط بعوالم الشرق الساحرة ؛ بدءا بمقامات بديع الزمان الهمداني ، وصولا إلى عوالم الحريري الفاتنة ؛ قرنان من الزمن عاشهما إميل حبيبي لحظة بلحظة ، فضلا على عشقه الأزلي الدفين لكتب السير و التاريخ و الفلسفة . وبهذا ، يظل الإبداع عند حبيبي مطرزا بقيم معرفية متعددة المشارب والمناهل. ففي رواية ” سرايا بنت الغول ” ابتكر إميل خطابا روائيا هجينا ، يمزج فيه الخيال بالأسطورة ، مادامت هذه الأخيرة تعد الحجر الزاوية في بنية العقل العربي . و مهما اختلفنا حول مسار الروائي الفلسطيني إميل حبيبي ، إلا أنه يظل واجهة ثقافية يقام لها ويقعد . ولا ننسى ما فعلته ، أيضا ، الأديبة و الروائية المصرية رضوى عاشور في روايتها ” الطنطورية ” ، حيث استطاعت أن ترسم ببهاء و حنية حياة الفلسطينيين ، الذين هُجِّروا قسرا من قراهم ، في هذا العمل الروائي الرائد . وذلك عن طريق خلق صور تبقى خالدة في الذاكرة ، تقول : ” غريب .كل امرأة شجرة .أقصد كل امرأة ولها شجرة . هناك . ليمونة أم سمير . برتقالة أم إلياس . خروبة أم هنية . لوزة أم العبد . نخلة أم الناهض . توتة أم محمد تينة أم صباح …” مثلها مثل عندما تحتفظ النساء الطنطوريات في جيدهن بمفاتيح منازلهن ، كحلم العودة إليها بعد التهجير . تقول رضوى عاشور ” مدت أم إبراهيم يدها في صدرها ، وأرتني المفتاح المعلق في حبل حول رقبتها . قالت : مفتاح دارنا . لا حقا سوف أعرف أن أغلب نساء المخيم يحملن مفاتيح دورهن تماما كما كانت تفعل أمي . البعض كان يريه لي ، وهو يحكي عن القرية التي جاء منها . وأحيانا كنت ألمح طرف الحبل الذي يحيط بالرقبة و إن لم أر المفتاح . وأحيانا لا ألمحه ، ولا تشير إليه السيدة ، ولكنني أعرف أنه هناك ، تحت الثوب .”
بهذه الصور السردية ، يكون الأدب الفلسطيني ، قد حفر أخاديد في الوجدان العربي ، ونحت على صخرة الشهداء بأظافر الأدباء و الشعراء و المفكرين . فما كان لهؤلاء إلا أن يرسموا سمتا نحو المقاومة بالقلم و المواقف الإنسانية ، التي لا تنحاز إلى الفئوية والطائفية ، وإنما تدافع عن قيم العدالة و الحرية و نبذ العنف ؛ لأنه بقدر ما يكون البيت متراص الأركان والدعامات ، بقدر ما يتنفس فجرا جديدا آت من وراء غيمات ندية . تماهيا مع خالدة ميخائيل نعيمة البسكنتي
سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر
فاعصفي يا رياح وانتحب يا شجر
و اسبحي يا غيوم و اهطلي بالمطر
وبانتظار سوبرمانات التغيير ، حسب تعبير أدونيس ؛ أطفال الحجارة . وعلى ضوء ذلك ، نكون على أهبة زمن جميل آت ، نحس به يدب دبيب النمل في الشعور والإحساس ، فيكبر و يكبر … ريتما يشتد عوده ؛ فيدوي كالرعد أيام الشتاء .
رشيد سكري – مغرب الثقافة

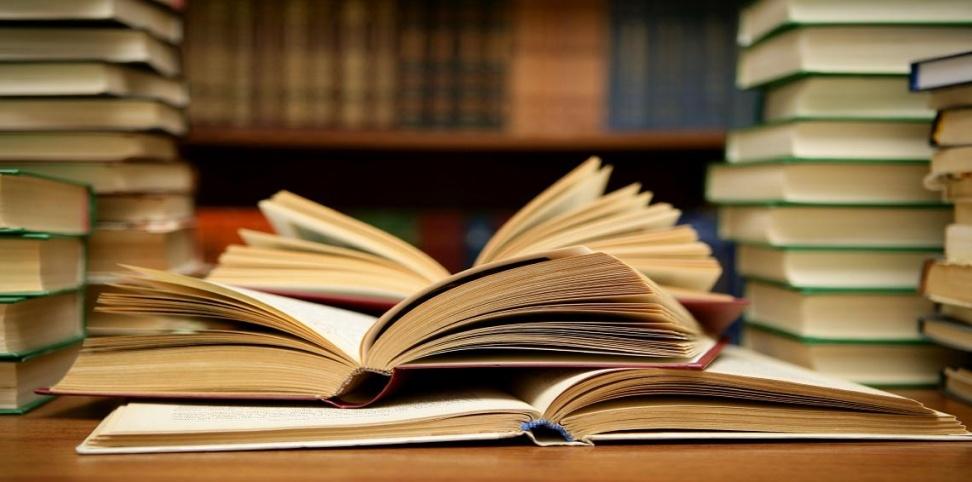




اترك تعليقا